Your cart is currently empty!
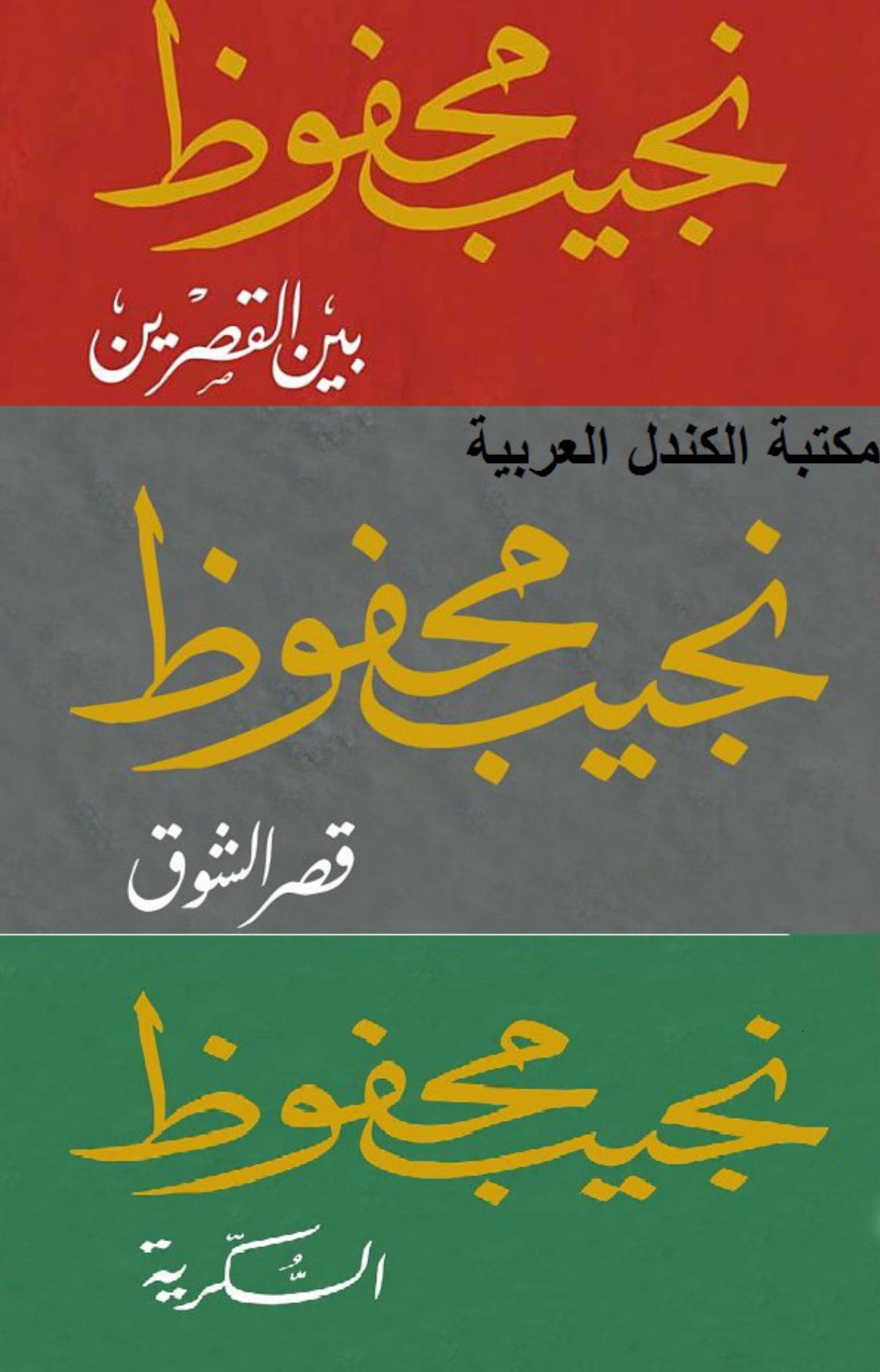
ثلاثية القاهرة لنجيب محفوظ
ثلاثية القاهرة أو ثلاثية نجيب محفوظ هي رواية من ثلاثة أجزاء كتبها الأديب المصري الراحل نجيب محفوظ ونشرت في عامي 1956 و 1957، وتكونت من ثلاث روايات هم: بين القصرين، قصر الشوق، والسكرية، لم تتح لي فرصة قراءة الثلاثية في وقت سابق للأسف، ولكن بعد أن قراتها مؤخرًا زال عني استياء تأخر قراءتها، فقد أدركت أن الثلاثية بحاجة إلى نضج حقيقي لفهمها من ناحية، ولتصفية محتواها الذي رأيت في بعض مواضعه أنه جدير به أن يميز بملصق “للكبار فقط” من جهة أخرى، على كل حال، سأحاول في هذه المراجعة أن أقدم رأيي في الثلاثية، وأن أحلل بعض أهم ما جاء فيها.
ملخص ثلاثية القاهرة:
تروي ثلاثية القاهرة تاريخ أسرة مصرية في الفترة من 1918 وحتى 1946، وتصف تطور عدة أجيال، أبطال الثلاثية هم أسرة السيد أحمد عبد الجواد وهم: زوجته السيدة أمينة، أولاده ياسين، خديجة، فهمي، عائشة، وكمال.
يمكن تلخيص أحداث الثلاثية والتي يصعب أساسًا تلخيصها على النحو التالي:
يتزوج السيد أحمد من سيدة ويطلقها بعد أن تحمل طفله الأول في أحشائها، ثم يتزوج من السيدة أمينة التي نشأت نشأة دينية صالحة، تنجب له أمينة بقية الأبناء وهم: فهمي، خديجة، عائشة، وكمال، ويعود ابنه من زوجته الأولى ليتربى في أحضان أمينة.
تتسم شخصية أحمد عبد الجواد بالازدواجية، فهو أب صارم، متحفظ، منضبط، ومتدين داخل بيته، لكنه رجل ضاحك، ودود، محب للخمر والطرب والنساء بين أصحابه.
تتزوج ابنتي السيد أحمد من شقيقين لأسرة ثرية ذات أصل تركي، ويموت ابن السيد أحمد الأكبر من أمينة -فهمي – في إحدى المظاهرات السلمية، ويتغير سلوك الأب ويميل للاعتدال نوعًا بعد وفاة ابنه.
يكبر الابن الأصغر للسيد أحمد – كمال – ويقرر الالتحاق بمدرسة المعلمين ضد رغبة أبيه الذي يرى أن مستقبله في الحقوق، ويبدأ الأبناء بالخروج عن الأب شيئًا فشيئًا.
يرتكب الابن الأكبر ياسين خطأ فادحًا مع الخادمة فيقرر والده تزويجه من ابنة صديقه زينب، لكن ياسين يتمسك بسلوكه السيء وينتهي به الأمر للطلاق وابنه في أحشاء طليقته أيضًا.
يتقرب كمال الابن الأصغر من مجموعة أصدقاء جدد من طبقة اجتماعية أعلى، ويتورط بحب شقيقة صديقه التي لا تبادله الحب، تتزوج الفتاة وترحل ويظل هو عالقًا بحبها، وهائمًا على وجهه في الفكر والفلسفة، وتنقلب أحوال كمال من شاب متدين وملتزم لشاب يعاقر الخمر ويعاشر فتيات الليل، ويتحول بفكرة للا دينية، وينتهي أمره بالعزوبية الدائمة.
يموت زوج الابنة الجميلة الصغرى عائشة بالتيفود، ويموت معه أبنائها الذكور، ويتبقى لها ابنة واحدة تلحق بأخواتها وهي عروس أثناء ولادتها لطفلها الأول، تنقلب حياة عائشة وتقصم ظهر الأب والأم معًا.
يكبر جيل الأحفاد، ويسلك أحدهم مسلك الإخوان المسلمين، والآخر الشيوعية، والثالث هو رضوان ابن ياسين من عوَّادة أحبها وتزوجها واختارت أن تقضي بقية عمرها كسيدة محترمة ومحتشمة وهي زنوبة، يشق رضوان طريقًا مختلفًا وغامضًا، ويبدو متسلقًا وناجحًا كذلك.
تنتهي القصة بموت الأب ثم الأم، وبقاء كمال أعزب، وعائشة مدمرة نفسيًا، وأبناء خديجة في المعتقل السياسي.
التحليل الفني للثلاثية
بطولة الكورال
الثلاثية كعمل أدبي تعتبر عملًا طويلًا وضخمًا وثريًا، وقد اعتمدت على البطولة المتعددة أو الكورال، وهو أسلوب مرهق في الكتابة والقراءة، فلا يوجد في القصة بطل وبطل مضاد، ولكن يوجد طائفة من الأبطال يعيشون معًا في حقبة زمنية واحدة، ويؤثرون ويتأثرون ببعضهم البعض، ولكل منهم قصته وهدفه الدرامي.
تشبه ثلاثية القاهرة في شكلها الفني رواية مائة عام من العزلة لجابرييل ماركيز، على أن الأخيرة بها من الخيال والسحر الكثير، لكن كلتاهما تعتمد على بطولة الكورال، وتدور حول أجيال متعاقبة لأسرة واحدة، وكلتاهما تخلوا من الشخصية المرجعية السوية، وكلتاهما سوداوية وكئيبة لحد كبير.
الزمن الداخلي
الزمن الداخلي في القصة طويل ويمتد لقرابة العقود الأربعة من الزمن، وتعتمد القصة على حقبة تاريخية حقيقية، وقد أرخت الثلاثية للحياة السياسية في مصر بشكل قوي، صورت بدايات ثورة 1919، تكون حزب الوفد، نفي سعد زعلول لمالطة، رجوع سعد، محاولات التحرر من الاستعمار الانجليزي، تغير الوزارات، العلاقة بين الوزارات وسرايا الملك، وانتهت أحداثها في خضم الحرب العالمية الثانية.
ومن الناحية الاجتماعية فقد وثقت الثلاثية الكثير من الجوانب الاجتماعية والأخلاقية والفكرية والدينية الموجودة في مصر وقتها، العادات، الأسماء، مظاهر البيوت من الداخل، المأكولات والمشروبات، الملابس، المفردات اللغوية، النكت، الأغاني، أسماء المطربين والمنشدين، وسائل النقل، أسماء الشوارع، تطور الأفكار الاجتماعية المتعلقة بالزواج والطلاق وعلاقة الرجل بالمرأة، الأفكار المتعلقة بالتعليم، مظاهر التدين، التعلق بالأضرحة، حب الحسين والسيدة زينب، الخ.
وأظهرت الثلاثية التناقضات الفكرية الموجودة وقتها كالتدين وشرب الخمر في وقت واحد، الحرص على الزوجة العفيفة والغيرة المفرطة عليها والتمتع بالعالمات في نفس الوقت، وغيرها.
اللغة والحوار
لغة الرواية قوية وجميلة، وقد اعتمدت على السرد من الخلف، فالراوي يتحدث عن بواطن الشخصيات، وجمعت بين صوت الراوي الخارجي، وبين أصوات الرواة الداخلية، فنجد أحيانًا النص يصف أمينة، وأحيانًا نجد أحمد عبد الجواد يتكلم عن نفسه وهكذا.
يبدو الوصف طويلًا وبه الكثير من الإسهاب في الكثير من المواضع، وثمة إسهاب في مواضع بعينها جعلتني أرى أن الرواية جديرة بملصق “للكبار فقط” كما ذكرت سابقًا، مع ذلك نجد براعة في تمييز نبرة كل راوٍ عن الآخر.
نبرة كمال كانت الأكثر إرهاقًا وإزعاجًا بالنسبة لي في الثلاثية: كثير الشك، كثير التفكير، كثير السفسطة، كثير التكرار، وقليل الفعل، وبدا لي بطريقة السرد التي اختيرت له بأنه شخصية سلبية على أرض الواقع رغم محاولاته للتظاهر بأنه إيجابي ومنتج، هو رمز للضياع والشلل الفكري رغم غزارة المعلومات المتاحة من حوله، وفرصته أن بنهل منها.
بناء الشخصيات
امتازت شخصيات الرواية بأنها رمادية، فلا توجد شخصية خيرة وأخرى شريرة، لكل شخصية جوانبها المضيئة والمظلمة، وجميعها شخصيات مركبة ذات طبقات متعددة، لها ماضٍ تأثرت به، وحاضر تعيشه، ومستقبل ترسمه بقراراتها وإرادتها.
لكن خلت الثلاثية من الشخصية الطبيعية أو المرجعية، فجميع الشخصيات متطرفة في صفاتها كثيرًا، لذا قد تشعر عند قراءة العمل بالإجهاد النفسي الشديد، لا يوجد ما تستند إليه، ولا شخصية تطمئنك ولو قليلًا بأن الدنيا لا زالت بخير، هذا لا يعد عيبًا أو انتقاصًا من العمل طالما كان إرادة الكاتب التي يحركها هدف معين، فإن كان نجيب محفوظ يريد أن ينقل لنا شعور التأزم والضياع وغياب القدوة فهو قد نجح بجدارة.
موضوعات عالجتها الثلاثية
الرجل في ثلاثية القاهرة
لقد فضح نجيب محفوظ الرجال وهتك أسرارهم، نعم هذا ما شعرت به بعد إغلاق الثلاثية كاملة، فلقد ناقشت الثلاثية موضوعًا غاية في الحساسية من خلال أجيال أربعة، وهو فلسفة وكيفية تعامل كل جيل مع مشكلة لا تنفك تظهر في المجتمع الرجالي، مشكلة تتسم بالصراحة الشديدة والتي قد تخدش حياء بعض القراء وخاصة من القارئات وهي “الشهوة”، نعم تناقش القصة حب الرجل للمرأة واشتهائه لها، وعدم اكتفائه بامراة واحدة، لذا أجدني أقولها بصراحة: لقد فضح نجيب محفوظ الرجال وهتك أسرارهم.
يرى البعض أن الثلاثية قد ناقشت تطور ثلاثة أجيال فقط هم جيل الآباء والأبناء والأحفاد، لكن في بعض جوانب القصة نجد حضورًا ولو من بعيد للجيل الرابع السابق، وهو جيل والد السيد أحمد عبد الجواد، وهذا ما سأشرحه في الأسطر التالية.
تستعرض القصة تطورًا في طريقة تعامل كل جيل مع مشكلة اشتهاء الرجل للمرأة، ففي حين سعى والد السيد أحمد عبد الجواد لإشباع هذه الشهوة بطريقة مشروعة دينيًا، وإن كانت مكروهة اجتماعيًا إلى حد ما، فقد عالجها ابنه وحفيده بطرق مختلفة، ثم جاء من الجيل الرابع من عاد ليقترب من صورة الجد الأكبر.
والد السيد أحمد عبد الجواد كان رجلًا محبًا للنساء، كثير الزيجات، يتزوج من أربعة فيطلقهن ويستبدلهن بغيرهن، لكن الرجل مات دون أن يتعدى نصيبه من الأبناء سوى ابن واحد فقط، وقسمت تركته على الزوجات الأربعة اللاتي بقين في عصمته وقت وفاته.
لهذا نشأ أحمد عبد الجواد ناقمًا على سلوك الأب الذي اعتبره سببًا في هذر حقه في الميراث بطريقة شرعية لا يمكن الفكاك منها، واتجه السيد أحمد لمعالجة شهوته هو الآخر بطريقة أخرى قامت على عدة مبادئ، وكانت له فلسفته الخاصة.
تزوج السيد أحمد وقرر أن يكتفي بزوجة واحدة كي لا تقسم تركته على نساء لا يستحققنها ويضيع بذلك حق أبناؤه فيها، واتخذ من الخليلات ما يشبع به رغبته، ووضع لنفسه دستورًا أخلاقيًا في اختيار الخليلات، فالجارات وأخوات وأقارب الأصدقاء محرمات بالنسبة له، والخليلة يجب أن تكون ذات حظ وافر من الجمال والسيط، ولم يأنف أن تكون عالمة ما دامت جميلة، شهية، ومشهورة.
وبدأ أحمد عبد الجواد يعاني من ازدواجية شديدة في حياته، وفصل الدين عن سلوكه اللاهي معتبرًا أنه يعطي لكل ذي حق حقه، فينال بيته الوقار والهيبة والاحترام وحسن تربية الأبناء ومراعاة سلوك الزوجة، وينال نفسه حظها من الضحك والطرب والعشق والخمر.
ولم يرد أحمد عبد الجواد عن ازدواجيته سوى الحزن فالمرض فكبر السن، جاءه النصح من رجل دين كان على صلة بوالده، وكان يشيد بسلوك والده الذي يبغضه أحمد، فلم يعر نصحه بالًا وإن كان يثقل عليه فيشعره داخليًا بالذنب، رآى ابنه يسلك مسلكه فغض الطرف معتبرًا ابنه رجلًا ناضجًا وموظفًا يتقاضى راتبًا، وأنه يفعل كما يفعل الرجال، لكنه تاب فترة بفعل الحزن على وفاة ابنة الشاب، ثم جاءته الضربة القاصمة والمؤلمة حين تلاعبت به زنوبة العوادة طالبة منه الزواج فأبى، وثار لكبريائه على رفضها وتمنعها عنه حتى يحقق لها مرادها، فهجرها سنينًا، وهجر معها النساء جميعًا، حتى عاد لطبعه فباغته المرض في لحظة اشتهاء زبيدة العالمة ليضع حدًا لازدواجيته.
أما الأبناء فقد شق كل منهم طريقًا مختلفًا، وكان لكل واحد مذهبه الخاص في التعامل مع النساء، وتعلم كل واحد ممن سبقه وأضاف إليه.
ياسين الابن الأكبر حذا حذو ابيه، لكنه انحط وتردى أكثر فأكثر، فلم يتبع دستور أبيه الأخلاقي، كل النساء حلال لعينيه ويده، ولا يشترط أن تكون الخليلة جميلة أو ذات شأن، لا بأس بالجارية والخادمة وبائعة الدوم أيًا كان مستوى جمالها ووضعها الاجتماعي، داخل بيت الأب أو خارجه في الشارع، قريبة أم امراة غريبة، وانحط ياسين أكثر فأكثر فكان الصورة الحيوانية في أقبح معانيها، لدرجة أن يشتهي والدة الفتاة التي ذهب لخطبتها، فحظى بالأم ومن بعدها البنت في صورة مقززة للغاية.
وعلى عكس أحمد عبد الجواد فإن ياسين لم يرتجع ولم يرده عن سلوكه شيء، لا الطلاق، ولا الفضيحة، ولا الأبوة، وانتهى به الحال للزواج من العوادة التي كانت خليلة له ولوالده فيما مضى، وتلك العوادة سيكون لها نصيب وافر من هذه المراجعة.
الابن الثاني فهمي كان له منهجه الخاص أيضًا، وإن كان فهمي قد مات شابًا ولم تُظهِر القصة ما كان سيحدث له لو أنه بقي؛ إلا أننا نرى خليفته الطفل الصغير الذي شب وكبر حتى بلغ الأربعين وهو كمال.
كان فهمي نموذجًا للأخلاق والأدب والوطنية المفرغة، هو يقول كلامًا جميلًا، ويظهر بمظهر لا يشوبه شيء، لكن داخله رجل يشتهي ابنة الجيران، ويمنح نفسه الحق في النظر إليها والافتتان بها، بل إنه قد بلغ به أن ينظر إليها من حيث لا تراه وهو يحاول إقناع ضميره وتخديره بأنها لا بد تشعر به، وأنها راضية، وكأن رضاها ومباركتها ليس علامة خطر من المفترض أن تقرع جرس الإنذار بنفس شاب يظهر ما يظهره هو.
لكن فهمي يسير على خطى الجد، يطلب خطبة الفتاة فيرفض والده، فيمرض بها عشقًا، ويموت فهمي دون أن ينالها، لكنه يعرف قبل موته بأن فتاته – التي خدَّر ضميره بأنها تشعر به وتقبل نظراته – كانت تغازل جنديًا إنجليزيًا، فهل كان سيتوقف عن حبها؟ هل كان سيخطبها إذا تخرج وتوظف كما اشترط والده؟ لم تجب القصة على لسان فهمي وإن أجابت على لسان غيره، فياسين الذي كان يعرف بحب شقيقه لها، وبمغازلتها للضابط الانجليزين- كان يعرف لكنه أغرم بها أيضًا، وخطبها وتزوجها، وخانها في بيتها وطلقها، والأبناء يحملون في عروقهم دم واحد للأسف.
كمال الذي بدأ طفلًا ثم شابًا ثم انتهى أربعينيًا كان مأساة حقيقية، تظهر من الجزء الأول إشارات خفية تشي بتشوه شخصية كمال مثل ملاحظاته للجارة المحبة للغنج والتي انتهى بها المطاف لتكون خليلة والده في فترة من الفترات، وابنة الجيران التي أحبها شقيق فهمي، والتي كانت تقبله من شفتيه وهو طفل دون التاسعة، وافتتانه بأخته عائشة لجمالها ورغبته في الشرب من موضع شفتيها، وكراهيته للزواج حين تزوجت شقيقتيه وغادرتا البيت، وتصوره المشوه عن الزواج، ومصادقته للإنجليز، ووشايته بابنة الجيران التي تغازل أحدهم، لقد كانت طفولة كمال مليئة بالإشارات المرعبة.
حين قارب كمال العشرين خبر الحب وليس الشهوة على عكس شقيقيه، هل افتقد الشهوة تمامًا؟ بالطبع لا، لقد اشتهى ابنة الجيران التي كانت تقبِّله ثم رغب بها شقيقه ثم غازلت الإنجليز ثم تزوجها شقيقه الآخر، لقد نجا كمال من حبها واشتهائها ليس لأنه قد اتخذ موقفًا منها، ولكن لأنها قد تزوجت وابتعدت حتى قبل أن تطلق فيتزوجها شقيقه الأكبر ياسين، لكن حين صار شابًا أحب فتاة حبًا عذريًا مرضيًا.
لقد كان حب كمال فلفسيًا غير واقعيًا على الإطلاق، كان يضخم كل ما في محبوبته على نحو شديد المبالغة، كان يصفها بالمعبودة، وكان يتعبد في محراب حبها، لم يكن ثمة تكافؤ بينهما لا في العمر، أو المكانة الاجتماعية، أو المستوى المادي، أو حتى في الأخلاق والطباع والدين، لكنه افتتن بها، افتتن بها لحد أنساه كرامته، سخرت هي منه، علم أنها تندرت عليه مع الجميع، كان أضحوكة في بيتها، ورغم كل ذلك كان يقبل ولا يغفر مدعيًا بأن للإله الحق في كل شيء، لقد كان كمال مريضًا بحق.
هل أراد كمال شيئًا من حبيبته؟ لا، حتى أن اعترافه لها بحبه كان اعترافًا مؤسفًا للغاية، هو يقول أحبك، فتسأل هي: “وماذا بعد؟”، فيجيبها: “اسمحي لي أن أحبك”، فتسأل من جديد: “وماذا لو رفضت؟”، فيجيبها بعبثية: “سأظل أحبك”، كمال كان نموذجًا العبث الحقيقي، هو يتوهم نفسه فيلسوفًا لكنه فارغ من الداخل، يحمل أفكارًا عبثية جدلية لا طائل منها.
هذا الحب العبثي دفع كمال للتطرف، فعزل الحب عن الزواج، وفصل الروح عن الجسد، وهام بصورة خيالية لمحبوبته، وحين تزوجت هي من غيره رآى أنها تنحط في الحياة وتمرغ نفسها بالوحل، لم يتقبل فكرة أنها حامل، شعر بالتقزز والابتذال، وظل يحبها لسنين طويلة وهي متزوجة من رجل آخر دون أي وازع ديني أو أخلاقي، وسخر منه القدر فجعله يمشي في جنازتها وهو لا يعلم من تكون السيدة المحمولة في النعش، لقد كانت حرم مديره التي ماتت وهي عروس لم تكمل سنتها الأولى، فحزن كمال، حزن لأنه لم يحزن عليها كما ينبغي، لا زال عابئًا بحق!
لقد عبر كمال عن ازدواجية جديدة لا تشبه ازدواجية والده، وكانت ازدواجية مركبة ومنحطه في باطنها، كان يريد امرأة يحبها حبًا روحيًا فقط، وامرأة يخلو بها جسديًا فقط، وكلاهما بلا زواج، خاف من الزواج، واعتبره نهاية لكل شيء: للحب، والفكر، والنشاط، والطموح، وغرق في وحل الدعارة، هجر الدين، وتحول إلى لا ديني، عشق الفلسفة والسفسطة.
وانتهى الأمر بكمال رجلًا في الأربعين من عمره فقد أبوه وأمه ومعظم أسرته، وبقي بلا زوجه أو أبناء، وبقي خائفًا على حريته المزعومة، ومحافظًا على فكره الذي لا يجلب له سوى المتاعب.
ثم جاء الأحفاد كثلاثة نماذج متمايزة: عبد المنعم شبيه الجد الأكبر الذي طالب بتزويجه لإعفافه حين قبض على نفسه متلبسًا مع ابنة الجيران، فزوجه أبوه وهو لا يزال طالبًا، ثم ماتت زوجته وهي تلد فأعاد الكرة ليتزوج ابنة خاله ياسين.
والحفيد الثاني هو أحمد الذي حذا حذو الخال فهمي ومن بعده الخال كمال، كان عابثًا في فكره، لكنه لم يسقط في هوة الحب العبثي كخاله كمال، صدمته الحياة مرة فأعاد التجربة، وتزوج من فتاة توافق فكره وإن لم توافق مستواه الاجتماعي والمادي.
والحفيد الثالث كان صدمة بالنسبة لي، إنه رضوان ابن ياسين من زوجته الأولى، نشأ مبعثرًا بين الأم والجد والأب، كره الزواج واشمأز منه، لكن القصة أوردت إشارات خفية فاجأتني وصدمتني حول علاقة رضوان بأحد الكبار من العزاب، كانت علاقة مريبة مع إشارات في الحوار لا يمكن غض الطرف عنها، الرجل عازب هو الآخر ورضوان يقول بأنه يشمئز من المرأة، فأي إشارة أوضح نحتاج إليها كقراء لندهش من جراة نجيب محفوظ في ذلك الوقت.
المرأة في ثلاثية القاهرة
تدرجت المرأة عبر الأجيال الأربعة كذلك في الثلاثية، وتغير دورها الاجتماعي، وتأثر هذا الدور بعاملين: مكونات شخصية المرأة.، وطبيعة الشريك أو الزوج الذي لعبت دور المتمم له.
فأظهرت الثلاثية طائفة واسعة من السيدات والفتيات، منهن عالمات (ليست مشتقة من العلم ولا هي مؤنث عالم) مثل جليلة وزبيدة، ومنهن من فُرض عليهن كار العوالم – بلغة القصة – مثل زنوبة العوادة، ومنهن سيدات فاضلات مثل زوجة السيد أحمد السيدة أمينة ووالدتها، ومنهن سيدات قويات الشخصية مثل خديجة ووالدة زوجها نعيمة حرم شوكت، وزينب طليقة ياسين، ومنهن لاهيات جميلات مثل عائشة، أو متهورات مثل مريم ابنة الجيران، أو سلبيات صغيرات مثل نعيمة ابنة عائشة، أو فاضلات هادئات مثل كريمة ابنة ياسين.
وعلى الجانب الآخر وجدت الشابات المتعلمات بأنواعهن، العابثات الجريئات مثل عايدة التي أغرم بها كمال، أو العمليات المتطلبات الجادات مثل علوية التي أحبها الحفيد أحمد شوكت، أو المثقفات الجادات الطموحات المكافحات مثل سوسن التي تزوجها أحمد.
وظهرت اللعوب منهن مثل والدة مريم التي أغوت أحمد عبد الجواد وابنه ياسين، والضحية في بيوت الدعارة مثل عطية، والجدليات مثل طليقة السيد أحمد عبد الجواد ووالدة ياسين.
ولعبت المرأة أدوارًا مختلفة في الثلاثية، ففي الجيل الأول حيث والد أحمد عبد الجواد ووالدة أمينة، في هذا الجيل ظهرت والدة أمينة كزوجة شريكة لزوجها، هادئة، لا تعاني من القهر، تحب زوجها وتذكره بالخير حتى بعد وفاته، وكانت تعتز به، ولم ترد في القصة إشارة لازدواجية الرجل أو جبروته، وكأن صورته كانت قريبة من صورة والد عبد الجواد، والفارق بينهما كان زهد الأول واعتداله في النساء مقابل شهوة الثاني وميله للتعدد.
يليه جيل السيدة أمينة والذي ظهرت فيه الزوجة الفاضلة مقابل المرأة اللعوب أو العالمة المتبرجة والمنحلة أخلاقيًا، وكان الزوج يعاني من الازدواجية، يحب سلبية الزوجة الفاضلة ويريدها طيعة وصدى لصوته، ويهيم باللعوب المنطلقة الإيجابية ويترك نفسه لها تضعه حيثما شاءت.
وكان نموذج السيدة أمينة نموذجًا حقيقيًا للزوجة الطيبة القانعة المطيعة، تعنى بشؤون بيتها من طلوع الفجر، تطبخ، تغسل، تنظف، تشرف، وتربي الأبناء، رصيدها من العلم محدود، ولا يوجد في جعبتها سوى بعض القصص الدينية والأساطير، لا تمارس أي هوايات، محرومة من كل مباهج الحياة، لا خروج من البيت، لا موسيقى، لا مسرح، لا فرحة حقيقية في يوم زفاف أبنائها، زوجة ترعى زوجها لحد الخدمة، لا تجالسه في طعامه بل تقف بانتظار أوامره، تجلس عند قدميه على الأرض، تخشاه وتهابه، ترضى مكرهه بسهره كل ليلة وعودته مخمورًا، تكره الخمر لأنها حرام، وتحبها لأنها تُلَيِّن طبعه معها.
لكن الجيل الذي تلا أمينة لعب فيه الزوج دورًا أخف وطأة، فسمح للزوجة بأن تبدي بعض الإيجابية، فكانت خديجة مع زوجها نموذجًا مختلفًا عن أمها، سيدة بيت من الدرجة الأولى، لكنها تعبر عن رأيها، تتكلم، تثور، تشارك في صنع قرارات الأسرة، وظهرت في وقت فراغها تمارس هواية التطريز، ولم يكن لها مجلس قهوة بسيط كمجلس أمها، ولكن زوج خديجة خليل شوكت لمن يكن كوالدها، كان رجلًا مترفًا عاطلًا بالوراثة، بارد الطبع، مقيمًا في البيت جل وقته، لا يسهر، لا يتخذ خليلات، لا يشرب الخمر سوى في المناسبات، وكان خاملًا وعاطلًا شكلًا ومضمونًا.
وكانت زينب كذلك مثل خديجة مع زوجها ياسين، قوية، لها رأي، ولها كرامة تدافع عنها، وقد وتمردت على نزواته وأخطائه واختارت الطلاق منه.
وفي نفس الجيل كانت زنوبة، وتلك لها فقرة كاملة نفردها لها.
ونجد في الجيل التالي فتيات مثل سوسن مثقفات، جريئات متعلمات، زوجات يشاركن الرجل ويسرن إلى جواره لا خلفه، لكن سوسن وعلوية – وهما من جيل واحد – كن باردات عاطفيًا، ولم تظهر القصة حنانهن أو عاطفتهن أو دلالهن كفتيات، بل ظهرن قويات مسترجلات.
لكل شيء ظاهر كثيرًا ما يخالف باطنه
عرضت الثلاثة فكرة التناقض بين الظاهر والباطن بقوة، وعلى مستويات عديدة، فنجد:
ظاهر السيد أحمد عبد الجواد في بيته رجلًا محافظًا منضبطًا، لكنه خارج بيته ضحوك، عابث وطرب، لدرجة أن يمسك الدف ويضرب به كما قالت زنوبة بأفضل من عيوشة الدفافة.
ظاهر فهمي كان وطنيًا يعشق سعد زغلول، وتجري في عروقه دماء الوفد، ويخرج للمظاهرات، ويوزع المنشورات، لكن فهمي بداخله كان جبانًا متخاذلًا، وقد عبر هو بنفسه عن ذلك، كان يخرج للمظاهره فيفزع إن سمع دوي الطلقات، فيسرع للاختباء، كان يحب الوطن ويتمنى أن يفديه بروحه، لكنه لم يحبه بصدق يجعله قادرًا على الإتيان بتلك التضحية، ولقد مات فهمي في مظاهرة سلمية، وكانت مفارقة جميلة في القصة، احتسبوه شهيدًا، لكنه شهيد خائب كان يهرب من المواجهة في المظاهرات الحقيقية التي يتوقع فيها الموت والاستشهاد، فجاءه القدر بميته غادرة في مظاهرة سلمية أمنتها الدولة، لكن عساكر الإنجليز لم يتمكنوا من ضبط أعصابهم فأطلقوا النار، ومات مع من مات حينها.
ظاهر كمال معلم ابتدائي ملتزم قد حقق حلمه الذي رفضه والده، لكن في باطنه كان يرى وظيفة المعلم كما رآها أبوه، كان يحتقر نفسه، يحتقر وظيفته، ولم تكسبه الفلسفة القدرة على تقديس رسالة المعلم للأسف، وكان ظاهر كمال في الصحافة فيلسوفًا جريئًا يخوض في موضوعات لا يقبلها الكثيرون، لكن في باطنه كان كاتبًا جبانًا يختار المجلات ذات التوزيع المحدود، ويخاف أن يقرأ رؤساؤه في العمل مقالاته، ويكتفي بالترجمة والتلخيص، وهو في حقيقته فيلسوف فارغ يدعي الفلسفة وهي منه براء.
ظاهر أمينة زوجة مطيعة وخيره، لكن باطن أمينة هو السلبية وعدم الاختيار، أمينة نشأت في بيئة نقية، وتزوجت من رجل يبدي التحفظ فكانت متحفظة، لكنها بلا كرامة، لدرجة أن استنكرت ثورة زينب على سلوك زوجها المنحل وسهره وشربه للخمر، ورضيت أمينة بسلوك زوجها هي واعتبرت سلبيتها طاعة، ونقصان شعورها بالكرامة كمالًا.
زنوبة العوادة
كانت زنوبة من أجمل شخصيات العمل رغم دورها السيء في الجزء الأول والثاني من الثلاثية، لكن زنوبة كانت الشخصية الوحيدة التي عبرت عن الإرادة الحقيقية، نشأت في بيت خالتها العالمة زبيدة، وتربت على التخت، وتعلمت العزف على العود، وكانت تحيي السهرات وتجالس الرجال وترضيهم كما علمتها خالتها، لكن زنوبة رغم انحطاطها ولعبها دور الخليلة للأب والابن إلا أنها ثارت على نفسها في لحظة حاسمة، امتنعت عن الأب طالبة الزواج لا المعاشرة الحرام رغم المال والنعم، رفض الأب وهجرها فتزوجت من ابنه ياسين، واحتضنت ابنه من زوجته الأولى رضوان، وهجرت كار العوالم، وتحولت بإرادتها لسيدة محترمة فرضت احترامها على أسرة زوجها رغم علمهم بماضيها، احتشمت في ملابسها، ولم تتزين خارج بيتها، واستطاعت كبح جماح زوجها الذي يجري الانحلال الأخلاقي في عرةقه مجرى الدم، وأنشأت بنتًا مهذبة وفاضلة هي كريمة، ووصفتها الرواية بأنها كانت تبدو أكبر سنًا من زوجها باحتشامها ووقارها.
في المقابل تهذب سلوك أحمد عبد الجواد بفعل عوامل خارجية كالحزن والمرض وكبر السن، وتهذب ياسين نوعًا بفعل زوجته وما أحاطته به من رعاية ومحاولة لكبح الجماح، وبقي كمال هائمًا على وجهه بلا إرادة، وبقيت أمينة سلبية مادام زوجها قويًا ومهابًا، لكنها نالت قسطًا وافرًا من حريتها بمرضه وكبره، فخرجت للشارع، وزارت الحسين والسيدة زينت مرات ومرات على علمه، وارتدت المعطف كالنساء المتحضرات، لقد كانت أمينة صدى لصوت أحمد عبد الجواد، وكانت منزوعة الإرادة.
شهود على العصر
أتت القصة بشخصيتين محيرتين بالنسبة لي، وأعتقد أنهما بحاجة لفترة أطول للتفكر فيهما رغم بساطة ظهورهما وهما:
الشيخ متولي الذي انتهت القصة به وقد جاوز المائة من العمر، أصيب بالمرض والزهايمر، ونسي كل من حوله، لدرجة تجاهله لجنازة أحمد عبد الجواد الذي كان على صلة بوالده وبه، وكان يحب أبناؤه ويكثر من دعائه لهم.
والشخصية الثانية هي أم حنفي الخادمة الأمينة التي لازمت الأسرة، لم تتغير أم حنفي طوال القصة، بقيت قوية، نشيطة، أمينة ومخلصة.
مآخذ على ثلاثية القاهرة
رغم قوة العمل على المستوى الأدبي إلا أنني أجد عليه بعض المآخذ أهمها:
تركيز القصة على شريحة واحدة من المجتمع المصري، وقد أدى هذا التركيز إلى تصوير المجتمع المصري غارقًا في الخمر والدعارة، وهو ما أثار ضيقي ونفوري كثيرًا.
المبالغة والإسهاب في وصف النساء ومفاتنهن، والتلذذ بالخمر، فأجدني أرى في الأولى خدشًا للحياء، وفي الثانية جرحًا لقيمة دينية متأصلة في مجتمع مسلم يعلم علم اليقين أن الخمر حرام، وملعون شاربها وساقيها وصانعها.
ثمة أيضًا حوارات كثيرة في تجمعات الأصدقاء من الجيل الأول، وأعني بهم أحمد عبد الجواب وأصدقائه، اتسمت هذه الحوارات بالمجون والإسفاف، ورغم أنها وثقت للكثير من مفردات العصر وثقافته، إلا أنها أثارت استيائي على المستوى الشخصي.
على كل حال، ثلاثية القاهرة عمل أدبي ضخم وقوي ويستحق القراءة، لكنه برأيي لا يناسب صغار السن من القراء، وقد يؤذي شعور الكثير من القارئات، وأرى فيه انتهاكًا صريحًا لمجتمع الرجال، وربما تصويرهم بأقبح مما قد يكون موجودًا وحقيقيًا، وفيه تهميش للنساء وللفاضلات منهن بشكل خاص، فالمرأة إما فاضلة، سلبية ، جاهلة، حنونة، أو متعلمة، صارمة، قاسية، أو جميلة، لعوب.
أضف المنشور للمفضلة
اشترك في مدونة نسمة السيد ممدوح
كن أول من يقرأ جديد المقالات والقصص والمراجعات
تعليقات القراء
أحدث المنشورات
سلسلة فيء الغمام لسحر خواتمي وهبة أعرابي
بداخل كل منَّا جمانة عليه أن يكتشفها ويحفظها، وجميعنا بحاجة لسلام يريح نفوسنا، وجود في عواطفنا، وكلنا نحلم بزينة تجمل…
في ظلال الفصحى
هل تساءلت يومًا عن الفرق بين منشور طويل على منصات التواصل الاجتماعي وبين كتاب تقرؤه؟ لقد تغير الواقع كثيرًا، وأسئلة…
أنا لا أخشى جحر الثعبان
مضت سنوات جاوزت العشر على مقال كتبته ونشرته على موقع مصراوي، حين قرأ أبي المقال قال لي: “لقد وضعتِ يدكِ…
نحن فنانون وأدباء ولسنا تجارًا
تلعب المسابقات دورًا هامًا في شحذ المهارات والقدرات واكتشاف المواهب، وتشبع كلًا من المتسابقين والجمهور نفسيًا، إنها تجربة فريدة تحمل…
مراجعة رواية “الشلال” للكاتب أحمد دعدوش

نسمة السيد ممدوح
كاتبة ومذيعة مصرية من مواليد 1986، حاصلة على ليسانس الآداب قسم الإعلام – إذاعة وتلفزيون عام 2008.
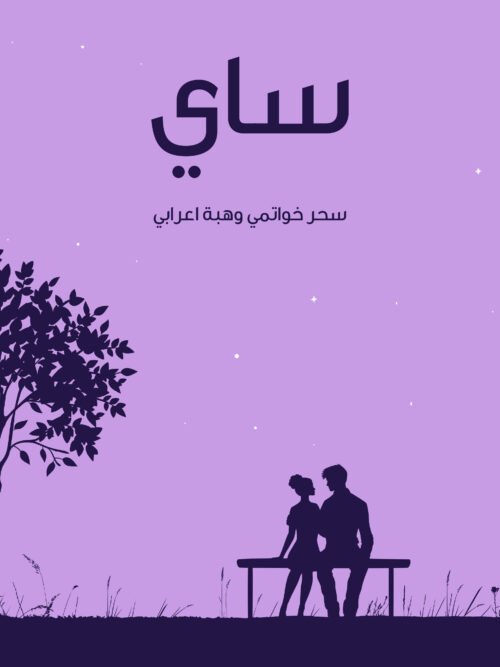
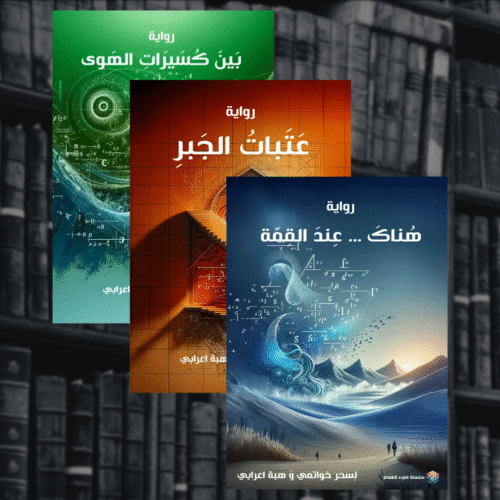
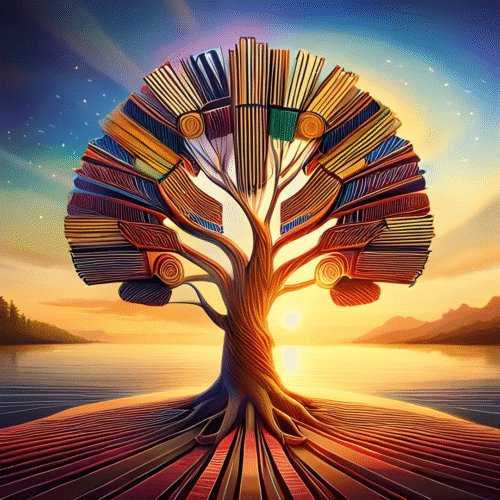


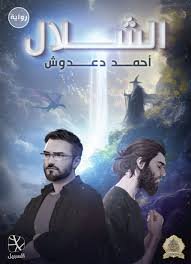
اترك تعليقاً