Your cart is currently empty!
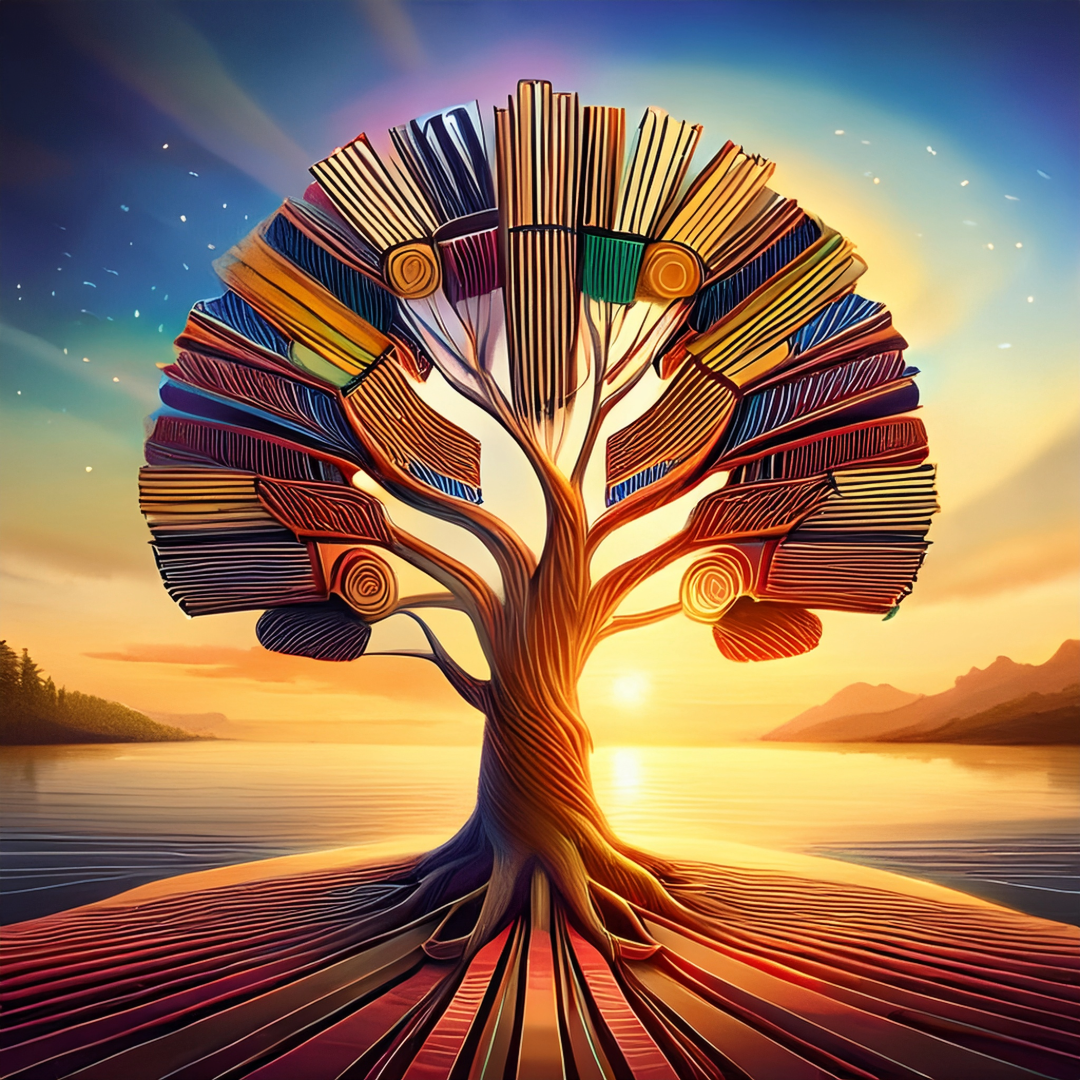
في ظلال الفصحى
هل تساءلت يومًا عن الفرق بين منشور طويل على منصات التواصل الاجتماعي وبين كتاب تقرؤه؟
لقد تغير الواقع كثيرًا، وأسئلة الأمس لم تعد أسئلة الحاضر، والجدل الذي تحركه النوستاليجا والحنين للماضي، أو التعصب الأعمي لن يكون قادرًا اليوم على فهم مشكلاتنا وأوضاعنا المعاصرة، تذكُر هذا الجدل حول أيهما أصح وأفضل وأبقى: الكتاب الورقي أم الإلكتروني؟ تذكُر هذا الترف الذي لا حاجة له، والتحذلق والادعاء المبني على الحنين للماضي وعشق رائحة الورق والمكتبات، والأفكار المثالية والانغلاق الفكري؟! لقد بات هذا كله ترفًا فكريًا ومحض سفسطسة نشغل بها فراغات الوقت، ونخلق بها حوارًا لا طائل منه.
ثمة مشكلات أهم من الوسيط الورقي والرقمي، مشكلات تتعلق بالفكر واللغة، بالطبع لا يسعنا في مقال واحد أن نتحدث عن الفكر، والفكر بطبعه بحاجة للحرية، مجاله واسع، وجميعنا بحاجة له حرًا طليقًا مبدعًا زاخرًا، المشكلة التي أكتب لك عنها اليوم هي اللغة، نعم اللغة.
لغة الكتابة للكتب والمؤلفات العربية
عندما تمد يدك لالتقاط كتاب من على رف المكتبة أو تقوم بتحميله من منصة كتب رقمية، فإنك تفترض لا شعوريًا أن الكتاب العربي سيكون مكتوبًا بالعربية الفصحى؛ لكن تمهل عزيزي، اليوم قد تجد كتابًا في مكتبة عربية لكنه مكتوب بالعامية، البعض يستاء من لفظة العامية، ويحاول تجميلها بقوله: “اللهجة المصرية”، مع ذلك أنا أصر على معاملتها معاملة مجردة من أي عاطفة، إنها عامية، لأنها لهجة العوام، ولأن العامية ستشمل المصرية، الليبية، السودانية، ، التونسية، الجزائرية، المغربية، السعودية، اليمنية، الإمارتية، الكويتية، البحرينية، العمانية، العراقية، السورية، اللبنانية، الأردنية، والفلسطينية، هل تعبت من هذا التعداد؟ّ تمهل من فضلك، فالعامية ستشمل أيضًا المصرية البورسعيدية، الصعيدية، الإسكندرانية، الشرقية، الدمياطية وهلم جرًا، وستشمل السعودية الحجازية والنجدية والقصيمية والنجرانية وغيرها، وقس على ذلك كل لهجة عامية في دولة عربية، أعتقد أنك الآن قد استوعبت أني أصر على لفظ “العامية” لشموليته وليس لحكمه الأخلاقي على تلك اللهجات أو أن في ذلك محاولة مني للانتقاص من تلك اللهجات المحلية، وأن أردت لفظًا ألين وألطف، فلنقل اللهجة المحكية.
ولنعد لنقطة البداية: الكتب العربية اليوم قد تكتب بالفصحى أو بالعامية، ولكن ليست كل الكتب سواء، ثمة كتب أدبية كالروايات والسيناريوهات والمسرحيات وكتب الشعر، وعلى الجانب الآخر كتب فكرية ووثائقية وتاريخية وعلمية، ولنكون منصفين فلننظر لكل قسم على حدة.
بأي لغة تكتب النصوص الأدبية؟ الفصحى أم العامية؟
دار النقاش والجدل، وانقسم النقاد حول جدوى استخدام العامية في الأدب وخاصة المنثور منه لعشرات السنين التي تجاوزت القرن وقاربت على القرنين، لا زال الجدل محتدمًا، ولكل فريق حججه، تمثل هذه الحجج إغراء شخصيًا لي وتدفعني للحديث عنها، وبالطبع سأطرح رأيي فيها بوضوح، كون حرية التعبير مكفولة للجميع، وكوني أحترم قلمي وفكري، وأمارس الكتابة بالفصحى منذ ما يقرب من عشرين سنة ولا أقولها فخرًا أو مباهاة؛ ولكن أحاول أن أنقل لك رسالة واضحة تجيب على سؤالك الاستنكاري الذي يدور بخلدك الآن: “ومن تكون أنت لتطرح رأيك في قضية بهذا الحجم؟”، أقولها لك بأني من أبناء هذه الصناعة، وعشت في كنفها سنينًا، وبالتالي صار لي رأيي في قضاياها.
حجج كتابة الأدب بالعامية أو باللغة المحكية
واقعية الأدب
“الأدب يعكس الواقع”، هذه الحجة صحيحة فعلًا، الأدب يعكس الواقع بمشاكله وقضاياه، وهذا هو منهج المدرسة الواقعية، عبِّر عن قضية حقيقية بنصوصك الأدبية، المس ألم الجمهور، صور همومه ومشاعره بدقة، لست بحاجة للتجمل، كن واقعيًا وهذا جمال بحد ذاته، وأنا أتفق مع ذلك، لكن هل ما يُكتب بالعامية اليوم ولو كان مجرد حوار يحقق هذا المبدًا فعلًا؟
برأيي الجواب هو لا، لأن العامية مليئة بالفخاخ والمزالق، ومن السهل جدًا أن يزل قلم الكاتب حين يكتب بها، وبدلًا من أن يكون بسيطًا سهلًا وقريبًا من قلب القارئ وواقعه – في المقابل تجده قد انزلق فعلًا للتبذل والرداءة والتفريغ والإسفاف، والشواهد كثيرة جدًا.
من ناحية أخرى الأدب فن، والجمال في الفن ضرورة، والجمال قد يأتي من دقة التصوير ولو كان الموضوع قبيحًا، لكن إبداع الكاتب وجمال لغته سيخلق التوازن المطلوب، فيخرج عملًا فنيًا جميلًا يناقش موضوعًا قبيحًا، ودعوني استشهد بتحفة السيد فكتور هوجو “أحدب نوتردام”، هل كان الأحدب بحد ذاته جميلًا؟ هل كانت حياة الغجرية واللصوص وحارتهم جميلة؟ هل كانت مشنقة جريف جميلة؟ لا، لكن إبداع الكاتب ووصفه ومعالجته كان هو منبع الجمال، لهذا فاستخدام العامية دون أن تضيف جمالًا للنص هو عيب وقصور وليس العكس، وتضمين النص ألفاظًا سوقية بالعامية وألفاظ سباب حتى لو كانت واقعية هو محل خلاف أخلاقي آخر سوف أتطرق إليه لاحقًا.
ولكن قبل أن أنتقل لحجة أخرى دعني أتأمل معك قليلًا في معنى الواقعية، وأسلط الضوء حول التطبيق الأعمى لها في الأدب، تصور معي رواية بطلها ألثغ ينطق السين ثاء، فهل من الواقعية أن يكتب الروائي كل أحرف السين على لسان البطل ثاء ليكون واقعيًا؟ ألا يكفيه أن يذكر هذا العيب في سياق مناسب ويترك الباقي لخيال الكاتب؟ إذن الواقعية كضرورة في الأدب هي واقعية الجوهر والمضمون لا المظهر، نحن بحاجة لنصوص تعبر عن واقعنا، قضايانا، مشاكلنا، تحاكي عصرنا، ولسنا بحاجة لنصوص تعبر بسطحية عن شكل واقعنا فقط، فتكتب لنا الجيم ياء في نص يرد على لسان كويتي، أو القاف همزة على لسان مصري.
صعوبة الفصحى وعجزها عن التعبير والوصول لقلب القارئ
“الفصحى صعبة”، هذه هي الحجة التي يرتكن إليها الكتَّاب وليس النقاد، وهنا يحلو لي الجدل والنقاش والدفاع عن الفصحى بدون تعصب، الفصحى ليست صعبة؛ ولكنها لغة ثرية ذات مستويات وطبقات، بعض تلك الطبقات صعبة على العوام، وبعضها صعبة حتى على الدارسين، وبعضها طبقات يتنافس فيها الأدباء، لكن طبقاتها السهلة كثيرة، إنها تلك الطبقات التي تُكتب بها مكونات المنتجات الغذائية، تعليمات استخدام الأدوية، كتيب تعليمات استخدام المكنسة، طريقة استخدام المبيد الحشري على العبوة، قوائم الطعام في المطاعم، أوامر التشغيل في الأجهزة الإلكترونية، واجهة منصات التواصل الاجتماعي، كتب المدرسة، الصحف، المجلات، ترجمات الأفلام والمسلسلات والبرامج الأجنبية، ملخصات الأفلام والمسلسلات على منصات المشاهدة بالطلب، الملخصات الترويجية على الأغلفة الخلفية للكتب والروايات، السير الذاتية، قصص الأطفال والناشئين، والقائمة طويلة جدًا.
كعربي، عليك أن تشعر بالخجل وأن تواري وجهك بعيدًا وتستره بكفيك إن كنت لا تستطيع قراءة هذه المستويات البسيطة من لغتك الأم، وكعربي وُلِد في دولة عربية، وتعلَّم في مدرسة عربية، وقرأ كتب المدرسة وأسئلة الامتحان وأجاب عليها بالعربية، فعليك أن تشعر بالعار الحقيقي حين تقول بأنك لا تستطيع كتابة جملتين بالفصحى البسيطة، أو أنك لا تفهم لغة الصحافة كما نسميها، وكعربي وُلِد في دولة أجنبية أو درس في مدرسة أجنبية ولم يعلمه أبواه أن يقرأ ويكتب لغته الأم بأقل مستوياتها فعليك أن تشعر بالخجل من نفسك ومن تقصيرك، وأن تستدرك الخطأ قبل فوات الأوان.
الفصحى هي لغة النخبة
العربية ليست لغة النخبة، وإن كانت بعض طبقاتها تلائم النخبة المثقفة فعلًا لأنهم يجيدونها ويمارسونها، لكن حتى تلك الطبقات ليست حكرًا عليهم، ولم يرثوها عن آبائهم، ولن يورثوها لأبنائهم كملك لهم حق التصرف فيه، اللغة العربية الفصحى لنا جميعًا كعرب، لغة ثرية قادرة على التعبير عن كل شعور وموقف وشخصية، لغة زاخرة آسرة، ستفهم العربية وستجيد الكتابة بها فقط لو أنك توقفت عن تكرار هذا الادعاء المحبط بداخلك “إنها لغة صعبة”، قل “إنها لغة قوية” قل “إنها بحر زاخر بالعجائب” قل “إن قواعدها كثيرة” لكن لا تقل بأنها صعبة، لا تتوقف عن ممارستها، لا تهجرها، فأنت عربي!
حين يختار الكاتب أن يكتب بالعامية فهو برأيي يختار الطريق الأسهل بالنسبة له، يختار لغة بلا قواعد، ولا معاجم، ولا مرجعية، حين تمسك بنفسك متلبسًا في موقف كهذا فتذكر أن العامية كثيرًا ما تكون اختيار الضعفاء!
الحجج التي ذكرتها حتى الأن كانت لأنصار العامية، لكن بماذا يحتج أنصار الفصحى؟
حجج كتابة الأدب بالفصحى
استمرارية النصوص وبقاءها حية
“الفصحى تطيل عمر النص وتوسع من نطاقه الجغرافي” ، هنا أقف أنا، أنحني وأخلع القبعة احترامًا، وأصفق لرأي يقول بأن الفصحى قادرة على توحيد اثنين وعشرين دولة عربية بلهجات محلية لا حصر لها، قادرة على توحيد مساحة جغرافية شاسعة، وأذكر الجملة التي كانت تصف جمهور سلسلة روايات مصرية للجيب “من المحيط إلى الخليج”، نعم، كانت روايات للناشئين بالفصحى البسيطة، وكان يقرأها جمهور عربي يمتد من المحيط الأطلسي حتى الخليج العربي، يقرؤونها لأنها عربية فصيحة مفهومة، مكتوبة بلغة وحدة، لغة لها معجم يشرح كل مفردة من مفرداتها، لها قواعد كتابة صحيحة، وقواعد إملاء، لغة واضحة محكمة، على الرغم من أن تلك الروايات كُتبت بأبسط طبقات الفصحى، لكنها مع ذلك سليمة.
سيقول قائل: “وما بالها اللهجة المصرية؟ إنها مفهومة في كل دول العالم العربي” وأنا أرد عليه رغم أني مصرية وأقول بأن تلك أنانية، جرب عزيزي المصري أن تقرأ رواية بحوار مكتوب بالعامية الجزائرية أو العراقية أو الكويتية لتفهم شعور شعب غير عربي يقرأ رواية حوارها باللهجة المصرية.
ولأن العامية تختلف من مدينة لمدينة، ومن قرية لقرية، ومن زمن لآخر، فإن قدرة الرواية المكتوبة بالعامية على الصمود والبقاء والانتشار ضعيفة، والدليل أن إرثنا الأدبي لليوم مكتوب في غالبيته بالفصحى، ولنا أن نتساءل حقًا هل كانت هناك مؤلفات بالعامية قد اندثرت مع الزمن؟ وأنا أتوقع بأن الجواب هو نعم، وإلا ما كان لأصحاب النقد أن يتجادلوا حول قضية غير موجودة من الأساس.
وحجة النقاد تلك تحديدًا تنطبق على الأدب المنثور بأكثر من الشعر، فالشعر منذ القدم تضمن كلامًا بلهجات محكية، وتعارف على الشعر بأنه أدب كُتب ليُسمَع لا ليَقرَأ على عكس الروايات والمقالات، ووقفت المسرحية بين الاثنين، وفي حين يوثق الشعر حالة وجدانية، ويروي لحظة من الزمن في مكان وزمان بعينهما، وفيه تظهر ذاتية الشاعر ولغته الخاصة، في المقابل يأتي النثر ليوثق فكرة، ثقافة، قضية، قيمة إنسانية، الخ، والروايات التي قد يُنظر لها اليوم من قبل شريحة لا بأس بها بأنها ليست إلا ضربًا من ضروب التسلية – هذه الروايات هي قالب من أهم وأغنى وأصعب القوالب الأدبية، قالب يحتاج لروائي ذو فكر وثقافة ولغة وعاطفة، وهي إرث أدبي حقيقي لا يمكن التنازل عنه، فكيف يجوز لنا كعرب أن نوثق هذا الإرث بلهجات محكية تموت وتتغير مع السنين؟!
القومية العربية ضرورة
“العربية مطلب وحاجة قومية”، هذا هو الخط الأحمر الحقيقي في القضية، نحن عرب منتسبون للغة تحمل نفس اسمنا، وكعرب فاتهم القطار منذ عشرات السنين مطالبون بالإمساك بطوق النجاة، نحن ننسلخ يومًا بعد يوم عن جلدنا، ننسلخ عنه لندفع ثمن تكاسل سنين طويلة، ندفع ثمن البقاء في عربة القطار الأخيرة، نضطر لإجادة اللغات العالمية التي تتصدر المشهد لندخل سوق العمل ونحصل تعليمًا أفضل، نضطر لذلك فعلًا، لكننا ننسى أننا في خضم هذا مضطرون للتمسك بقوميتنا وهويتنا، مضطرون لإحياء لغتنا لا وأدها، إن المعركة هنا ليست مع عدو ولكن مع أنفسنا، داخل بيوتنا وقناعاتنا، حين نمنح أنفسنا وأبناءنا الرخصة بأن الفصحى صعبة والعامية لا بأس بها في كل وقت ومكان فتلك كارثة حقيقية، لا زلت تشعر بأني أبالغ، إذن انتظر عزيزي حين أفرغ من الرواية لأحكي لك عن الكتاب الفكري المدون بالعامية فلربما غيرت رأيك.
“العربية لغة القرآن” وصلنا لنهاية الطريق، لا مناص هنا، إن كنت عربيًا مسلمًا – وهذا دين معظمنا – فإنك مطالب فعلًا بإجادة العربية، مطالب بإجادة الحد الأدنى أو حد الكفاف منها، لن تقرأ القرآن بالعامية، لن تقرأ تفسيره بالعامية، لن تصلي لله بالعامية، لن تقرأ التشهد في صلاتك بالعامية، وأنت مطالب بأداء هذا كله بالفصحى، ومطالب بفهمه واستشعاره، وإن كنت فعلًا تقدر على ذلك، فكيف تقول بربك أنك لا تجيد قراءة رواية بالعربية؟
دعنا إذن ننتهي من الروايات وهمها، فبعضها كُتب من أوله لآخره بالعامية، وبعضها قد قصر العامية على الحوار، وبعضها استخدم بعض مفردات العامية كحُلي يطعم بها الحوار، وقد رتبتها لك من الأسوأ لما هو أقل سوءًا بنظري، ولكن أمهلني دقيقة لأهمس في أذنك بسر يفضح كتَّاب الروايات بالعامية: إن كل شخصياتهم تنطق بلسان واحد، بألفاظ واحدة، بأسلوب واحد، أليس هذا دليلًا على فقر الكاتب اللغوي والفني برأيك؟!
لغة الكتابة للمصنفات الفكرية العربية غير الأدبية
ها نحن على مشارف النهاية، “الكتاب الفكري”، لأكون صادقة معك، لقد دفعني لكتابة هذا المقال كتابين، أولهما كان موضوعه جيدًا، وحرص كاتبه على توثيق الكثير من المعلومات فيه، ولكنه للأسف كتبه بالعامية، فجاء كمنشور طويل جدًا على إحدى منصات التواصل الاجتماعي، استخدم العامية لخلق مساحة من السخرية والتهكم في بعض الأحيان، وليتخفف في الكثير جدًا من الأحيان الأخرى، لكن ذلك المعطف الردئ الذي ألبسه لمؤلَّفِه دفع بي لحالة حزن حقيقية، وظل السؤال يتردد بداخلي: “لماذا أسأت لجهدك وأخرجته بهذا الشكل؟”، الكتاب الثاني كان كارثيًا بدءًا من صفحة الشكر والتقدير والمقدمة، الحقيقة أنني لم أطق إكمال هذا الكتاب، لقد كان فيه من التدني اللغوي والفني الكثير، ألفاظ سوقية، شباب يتجادلون ويسخرون من بعضهم البعض في التقديم والشكر، سخافات كالتي يمكن أن نراها في إحدى مجموعات Facebook، وهذا ما جعلني أبدًا مقالي اليوم بهذا السؤال: ” هل تساءلت يومًا عن الفرق بين منشور طويل على منصات التواصل الاجتماعي وبين كتاب تقرؤه؟”
يا عزيزي الحياة ليست لونًا واحدًا، ليس من الضروري أن تسقط كل ما تجده على منصات التواصل الاجتماعي على كل شيء آخر، المنشور الذي تكتبه هناك هو قالب مختلف تمامًا عن الرواية أو الكتاب، المنشور يعبر عنك كفرد: فكرك، ذوقك، لغتك، أخلاقك، الخ، لكنه ليس مرجعًا لشيء، لا يمكن أن يستند إليه باحث، لا يصح أن توثق به معلومة، لا تشترط فيه المرجعية ليكون أهلًا للنقاش، فهو منشور ذو رأي ذاتي محض، من يناقشه يناقش رأيك أنت، أما الفكر المدون في كتاب موثق فقد يتحول بعد سنوات لمرجع، وقد يقتبس منه باحث في إحدى رسائله، تصور أن يأتي باحث بعد عشرين سنة فيقدم لنا رسالة ماجستير بالعامية وقد اعتمد فيها على مؤلفات فكرية كُتبت بالعامية، تصور كيف يمكن أن تناقش تلك الرسالة ومراجعها وهي بالأساس قد كتبت بلغة لا مرجعية لها، لكل كاتب قاموسه الخاص وأساليبه وقواعده، لمن نحتكم إذا اختلفنا في مقصد المؤلف من لفظة ما؟ سؤال بسيط لكنه على قدر كبير من الأهمية، فكر فيه، واذكره في كل مرة يقع فيها كتاب قد كُتب بالعامية بين يديك.
وبعيدًا عن التوثيق والمرجعية فنحن أمام مشكلة أخلاقية حقيقية، تحت ستار الظرف واللطافة والبساطة تستخدم العامية لنقل المعاني وتمرير ألفاظ مبتذلة وطرق حديث شعبية من خلال مؤلف فكري يتحدث عن العلاقات الإنسانية، تصور حجم الكارثة؟! حين تقرأ أنت كتابًا فأنت تفتح عقلك للمعلومات، وتكون قدرتك على الامتصاص أعلى، وحين يُقدم الكاتب على هذا السلوك فأنت تكتسب المعلومة واللفظ المبتذل والأسلوب الشعبي، ما الذي يعنيه ذلك في النهاية؟ يعني أننا بهذا الأسلوب نعمد لخفض مستوى الوعي الجمعي في المجتمع، وندفع حتى بالمتعلمين والمثقفين والراغبين في تحصيل المعرفة للتدني والميل نحو الشعبية، نحن نقتل أي فرصة للترقي الفكري، ولا نرفع وعينا الجمعي، ونتشبث بكل الوسائل التي تبقينا دولًا وشعوبًا متخلفة جاهلة ونامية، نصر على أن نكون دول العالم الثالث بجدارة، نتنافس على تحقيق الأسوأ، وللأسف ننجح في ذلك.
ختامًا عزيزي، إن كنت لا تزال مصرًا على أن الفصحى صعبة وأنها عاجزة عن الخوض في موضوعات دون غيرها فأنا أريد أن أذكرك بأن الفصحى قد استخدمت سلفًا لتسجيل العلوم وكانت بداية العلوم الغربية، وبالفصحى كُتبت المؤلفات في كل الفنون، وبها ناقش الأدب مختلف القضايا، وصور بها الأدباء كل الطبقات الاجتماعية من الأرستقراطيين وحتى الصعاليك، أما عن صعوبة الأسلوب وتدرجه فأنا أدعوك لتقارن بين لغة الأديب مصطفى صادق الرافعي، والأديب يوسف السباعي، والدكتور نبيل فاروق رحمهم الله جميعًا وستدرك رحابة طيف لغتك الفصحى.
أضف المنشور للمفضلة
اشترك في مدونة نسمة السيد ممدوح
كن أول من يقرأ جديد المقالات والقصص والمراجعات
تعليقات القراء
أحدث المنشورات
مراجعة رواية ساي لسحر خواتمي وهبة أعرابي
سلسلة فيء الغمام لسحر خواتمي وهبة أعرابي
بداخل كل منَّا جمانة عليه أن يكتشفها ويحفظها، وجميعنا بحاجة لسلام يريح نفوسنا، وجود في عواطفنا، وكلنا نحلم بزينة تجمل…
أنا لا أخشى جحر الثعبان
مضت سنوات جاوزت العشر على مقال كتبته ونشرته على موقع مصراوي، حين قرأ أبي المقال قال لي: “لقد وضعتِ يدكِ…
نحن فنانون وأدباء ولسنا تجارًا
تلعب المسابقات دورًا هامًا في شحذ المهارات والقدرات واكتشاف المواهب، وتشبع كلًا من المتسابقين والجمهور نفسيًا، إنها تجربة فريدة تحمل…
مراجعة رواية “الشلال” للكاتب أحمد دعدوش

نسمة السيد ممدوح
كاتبة ومذيعة مصرية من مواليد 1986، حاصلة على ليسانس الآداب قسم الإعلام – إذاعة وتلفزيون عام 2008.
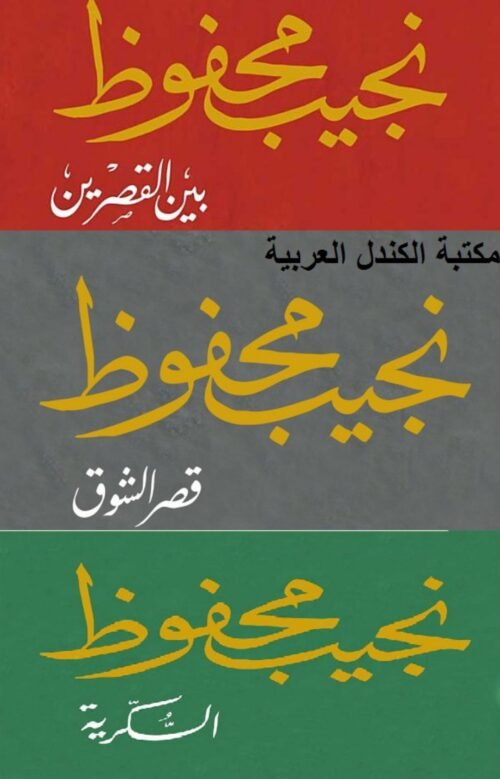
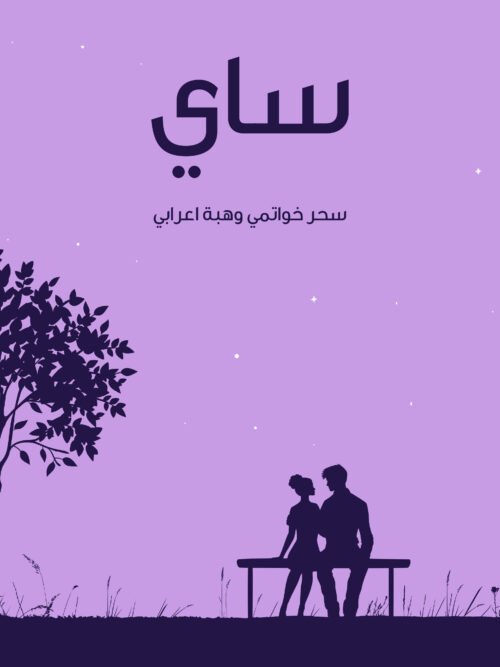
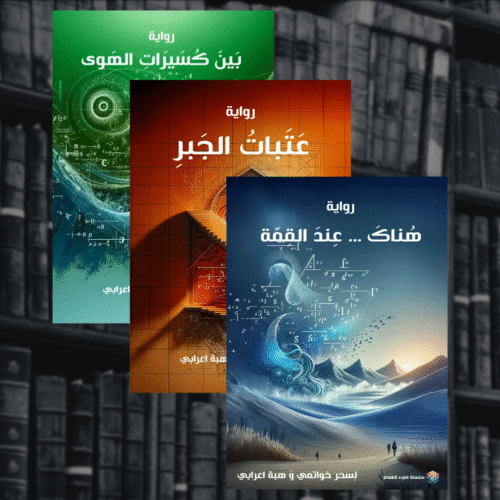


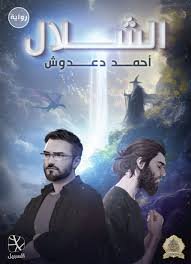
اترك تعليقاً